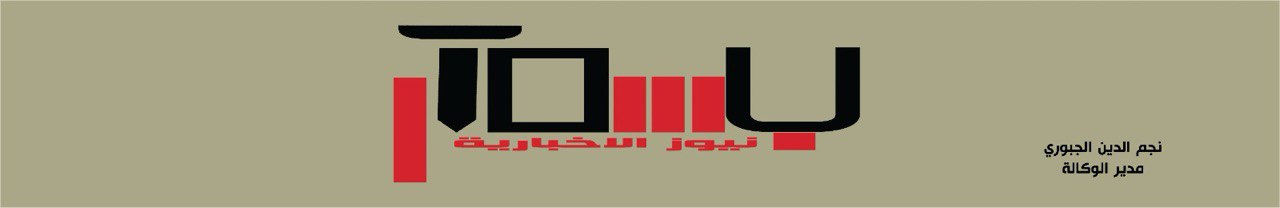العراق: سيادةٌ مُساوَمةٌ… شعبٌ مَخذول
( 24. تموز. 2025. )
بقلم/ عدنان صگر الخليفه
في قلبِ الشرقِ الأوسطِ المضطربِ، يجدُ العراقُ نفسهُ أسيراً لمعادلةٍ معقدةٍ باتَ فيها التغييرُ الحقيقيُّ حلماً بعيدَ المنالِ. إنها قصةُ بلدٍ تتقاطعُ فيهِ المصالحُ الخفيةُ مع الفسادِ المستشري وضعفِ الدولةِ، لتُشَكِّلَ جداراً سميكاً أمامَ تطلعاتِ شعبٍ أُنهكَتهُ الصراعاتُ وخذلتهُ الطبقةُ السياسيةُ.
تُعدُّ قضيةُ خور عبد الله نقطةَ تحولٍ جوهريةٍ ورمزاً صارخاً للتنازلِ عن السيادةِ العراقيةِ. ففيما يرى الشعبُ العراقيُّ ونخبةٌ من الخبراءِ أنَّ التنازلَ عن هذا الممرِّ المائيِّ الحيويِّ يمثّلُ تفريطاً بأرضِ الوطنِ ومقدراتهِ، تُصرُّ الحكومةُ ورئاسةُ الجمهوريةِ على أنَّه تطبيقٌ لقراراتٍ دوليةٍ لا رجعةَ فيها. هذا الإصرارُ، في نظرِ الكثيرينَ، ليسَ سوى استسلامٍ لمصالحَ تُغلّفُ بذرائعَ قانونيةٍ، ويُعززُ الاعتقادَ بأنَّ السيادةَ العراقيةَ باتتْ قابلةً للمساومةِ، خاصةً عندما يُنظرُ إلى نفوذِ دولٍ إقليميةٍ داعمةٍ في الساحةِ الدوليةِ. فالوجودُ التركيُّ في الشمالِ، والانتهاكاتُ المستمرةُ للسيادةِ من الجوارِ، كلها مؤشراتٌ على أنَّ مفهومَ “الحدودِ المفتوحةِ” باتَ واقعاً، مما يؤكدُ ضعفَ الدولةِ وعجزها عن بسطِ سيطرتها.
ويزدادُ الأمرُ تعقيداً عندما يُنظرُ إلى النفوذِ الغامضِ لشخصياتٍ سياسيةٍ نافذةٍ. فكيفَ يمكنُ لشخصيةٍ أنْ تحتفظَ بسلطةٍ هائلةٍ وتُمررَ اتفاقياتٍ مصيريةً، بينما لا تستندُ قوتها إلى قاعدةٍ شعبيةٍ كبيرةٍ، أو كتلةٍ برلمانيةٍ مؤثرةٍ (كتلةٌ لا تتجاوزُ الثلاثينَ نائباً لأكثرَ من عقدٍ ونصفٍ)، أو حتى مرجعيةٍ دينيةٍ واضحةِ المعالمِ؟ يرى كثيرونَ أنَّ هذا النفوذَ لا بدَّ وأنْ يكونَ نابعاً من “توافقاتٍ سريةٍ” أو “برامجِ تنازلاتٍ” تمَّ إعدادُها مع قوى إقليميةٍ ودوليةٍ، تضمنُ لهذهِ الشخصياتِ حمايةً وبقاءً في السلطةِ مقابلَ خدمةِ أجنداتٍ معينةٍ. فالكثيرُ من الاتفاقياتِ طويلةِ الأمدِ الغامضةِ، التي وُقّعتْ مع الولاياتِ المتحدةِ، مثلُ الاتفاقيةِ الإطاريةِ الاستراتيجيةِ عامَ 2008 والتي سبقتْ اتفاقيةَ خور عبد الله، يُنظرُ إليها على أنها مهدتْ الطريقَ لهذهِ التنازلاتِ. والمفارقةُ الصارخةُ أنَّ هذهِ الاتفاقياتِ، التي كانَ يُفترضُ أنْ تُعززَ الأمنَ وتُحصنَ الدولةَ، لم تمنعْ اجتياحَ تنظيمِ داعشَ لأكثرَ من ثلثِ العراقِ، ولم تُوقفْ انتهاكاتِ الجوارِ المستمرةَ، ولم تُحاربْ الفسادَ الذي ينهكُ الاقتصادَ. هذا الفشلُ المريعُ يُثيرُ تساؤلاً جوهرياً: ما الفائدةُ من تلكَ الاتفاقياتِ إنْ لمْ تُحققْ الأمنَ والسيادةَ، إلا إذا كانتْ أهدافُها الحقيقيةُ تتركزُ في حمايةِ مصالحَ أضيقَ وضمانِ بقاءِ طبقةٍ حاكمةٍ؟
إنَّ الموقفَ الرسميَّ للسلطةِ القضائيةِ في العراقِ، ممثلةً بـرئيسِ مجلسِ القضاءِ الأعلى، الذي يؤكدُ شرعيةَ اتفاقيةِ خور عبد الله وصحةَ التصويتِ عليها، ويصفُ القرارَ الأخيرَ للمحكمةِ الاتحاديةِ العليا بعدمِ دستوريتها بـ”اللغوِ القانونيِّ”، يُبرزُ مدى التماشي بينَ السلطاتِ الرسميةِ الثلاثِ. هذا التوافقُ يثيرُ شكوكاً حولَ استقلاليةِ القضاءِ ويسلطُ الضوءَ على احتماليةِ تسييسهِ لخدمةِ أجنداتٍ معينةٍ، خاصةً في ظلِّ إقالةِ قضاةٍ يُعتقدُ أنهم كانوا يحملونَ رأياً مغايراً. هذا الفصلُ الواضحُ بينَ موقفِ السلطةِ وإرادةِ الشعبِ يؤكدُ أنَّ الشعبَ العراقيَّ ومقدراتهِ في جانبٍ، بينما هذهِ الجهاتُ الرسميةُ والسياسيةُ تقفُ في جانبٍ آخرَ.
تزدادُ الصورةُ قتامةً عندَ مقارنةِ موقفِ المرجعيةِ الدينيةِ العليا من الدستورِ بقضيةِ خور عبد الله. فبينما كانَ تأييدُ المرجعيةِ الواضحُ للدستورِ العراقيِّ (بالإشارةِ للتصويتِ بـ”نعم”) عاملاً حاسماً في منحِهِ شرعيةً شعبيةً ودينيةً قويةً، فإنَّ غيابَ موقفٍ صريحٍ ومباشرٍ منها بخصوصِ اتفاقيةِ خور عبد الله، على الرغمِ من الرفضِ الشعبيِّ الجارفِ لها واعتبارها مساساً بالسيادةِ، يثيرُ تساؤلاتٍ جوهريةً. هلْ يُفسّرُ هذا الغيابُ بقبولٍ ضمنيٍّ، أو بتجنبِ صراعٍ مع الحكومةِ والقوى الدوليةِ؟ هذا التناقضُ يجعلُ العراقيينَ يتساءلونَ: ما هو الأهمُّ في نظرِ هذهِ الجهاتِ؟ الدستورُ الذي أُقرَّ بتأييدِ المرجعيةِ، أمْ السيادةُ الوطنيةُ التي يُفرَّطُ بها في قضايا مثلِ خور عبد الله دونَ تدخلٍ مماثلٍ؟
وفي خضمِّ هذا المشهدِ المعقدِ، يأتي الموقفُ المتماهي للمجتمعِ الدوليِّ والإقليميِّ مع النظامِ السياسيِّ العراقيِّ، رغمَ علمهمْ اليقينيِّ بفسادِهِ وقتلِهِ لشعبهِ وقمعِهِ للمتظاهرينَ. هذا التغاضي يؤكدُ أنَّ المصالحَ الجيوسياسيةَ والاقتصاديةَ تتفوقُ على المبادئِ الديمقراطيةِ وحقوقِ الإنسانِ. إنَّ مشاريعَ القوانينِ التي تُطرحُ في الكونغرسِ الأمريكيِّ، والتي تُدّعي “تحريرَ العراقِ من الداخلِ”، لا تعدو كونها أداةَ ابتزازٍ للحكوماتِ العراقيةِ لتحقيقِ مصالحَ أمريكيةٍ غيرَ معلنةٍ. ففيما يرى العراقيونَ أنَّ الولاياتِ المتحدةَ تستطيعُ التغييرَ برسائلَ مباشرةٍ، فإنَّ اللجوءَ لهذهِ التشريعاتِ يُشيرُ إلى تناقضٍ بينَ الخطابِ المعلنِ والممارسةِ الفعليةِ، مما يُعمّقُ الشكوكَ في النوايا الحقيقيةِ.
إنَّ الإغراءاتِ الهائلةَ في المالِ والمكاسبِ السياسيةِ والاجتماعيةِ تُعدُّ المحركَ الأساسيَّ لإصرارِ الحكامِ وذوي القرارِ، من الأطرِ السياسيةِ القديمةِ ذاتها، على المضيِّ قدماً بنفسِ المناهجِ الفاشلةِ. هذهِ المكاسبُ تضمنُ لهمْ البقاءَ في السلطةِ، بغضِّ النظرِ عن الكلفةِ الباهظةِ التي يدفعها الوطنُ والمواطنُ. هذا الواقعُ يدفعُ حتى بعضَ الجهاتِ التي تطمحُ للتغييرِ إلى التماشي مع السلطةِ، شعوراً منها باليأسِ وفقدانِ الحلولِ، إما خوفاً من المواجهةِ، أو طمعاً في بعضِ المكتسباتِ الجزئيةِ.
في الختامِ، إنَّ هذا الانفصالَ العميقَ بينَ الشعبِ والسلطةِ، ووقوعَ السيادةِ العراقيةِ فريسةً لمساوماتٍ داخليةٍ وخارجيةٍ، يرسخُ اليأسَ من إمكانيةِ التغييرِ الحقيقيِّ، ويُبقي العراقَ رهينةَ دورةٍ من الأزماتِ التي لا يبدو لها نهايةٌ في الأفقِ. فما لمْ تكنْ هناكَ إرادةٌ حقيقيةٌ لإعادةِ توجيهِ البوصلةِ نحو مصلحةِ الوطنِ والشعبِ، فإنَّ العراقَ سيظلُّ أسيراً لواقعٍ تُساوَمُ فيهِ السيادةُ ويُخذلُ فيهِ الشعبُ.