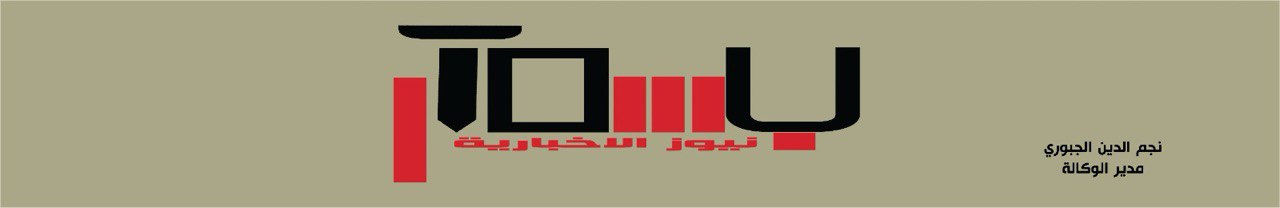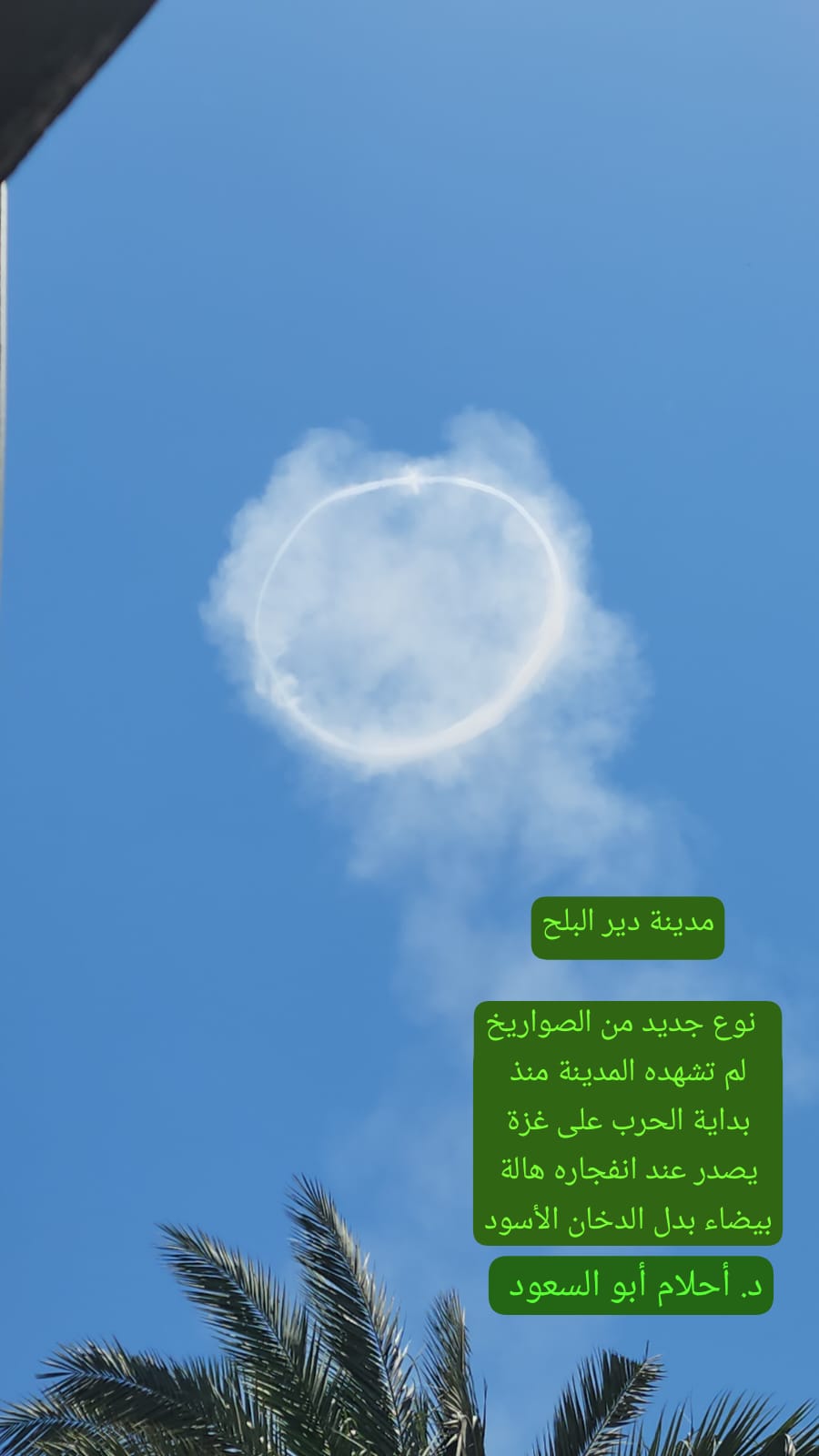حتى في الأسر:
عبّرت زينب عن موقفها
لا بانفعال بل بعزة وهدوء الحياء
علاء الطائي
كأن الأرضَ حين خُتمت المعركةُ في الطف… لم تطوِ صفحةً من الدم… بل فتحت كتابًا لا ينتهي.
كانت زينب وحدها تقرأ على الرمال أسماءً لم تُكتب بعد… وتُرخي على الأفق صرخةً لا يُغلق بابها.
لم تكن أسيرةً فقط… بل كانت تُحرّك التاريخ بسلاسلَ تُقرع كأجراسٍ في ضمير الزمان.
كلّ خطوةٍ لها في طريق الأسر… كانت كأنها تمشي على شظايا أخوةٍ ذُبحوا عطاشى…
وكانت تخبّئ في قلبها كلّ لحظةٍ من يومٍ لو وُصف بألف لسان… ما وَفَى حقّه أحد.
دخلت قصرَ يزيد… لا بخوف… بل بحقيقةٍ تمشي على قدميها.
كلّ عرشٍ ظالمٍ يخافُ من فكرة وزينب كانت تمشي وهي تحمل وجدان الأمة وصوت الحسين في صدرها.
نظرت إليه وقالت:
“لن تمحو ذكرنا… ولن تميت وحينا”
فارتجف الكذبُ… وخجلَ التاجُ من وضوح الموقف.
في تلك اللحظة… لم تُصبح زينب مجرد راويةٍ لكربلاء
بل صارت كربلاء ذاتها… بعيونٍ ترى ما لا يراه أحد… وبقلبٍ يُلملم شتات الأمة من خلف الخيام المحترقة.
ومضت الأيام… وجاء الأربعين.
فإذا بخطواتٍ تُعدّ على أرض العراق
ملايينٌ تسير نحو الحسين… لكن نداءها الأول كان “لبيكِ يا زينب”.
أجسادٌ متعبة… قلوبٌ مشتاقة… ودموعٌ لا تُكفكف إلا عند الضريح.
أي كلماتٍ بشريةٍ تُفسّر هذا العشق؟
كيف لم يُنسَ موقفٌ من أكثر من ألف سنة؟
وكيف صارت زينب مدرسةً تُخرّج الأحرار؟
لا جواب…
سوى أن زينب لم ترفع رأسها فقط.. بل رفعت أمةً كاملة… على جناحٍ من الصبر والصوت واليقين.
وفي نهاية هذا السرد… لا نملك سوى أن نردّد ما قالته الدموع والقلوب:
تخطّ المسيرَ والأقدامُ تسجدُ…
“لبيكِ يا زينب” تهزُّ السما وتُبدّدُ
علاء الطائي