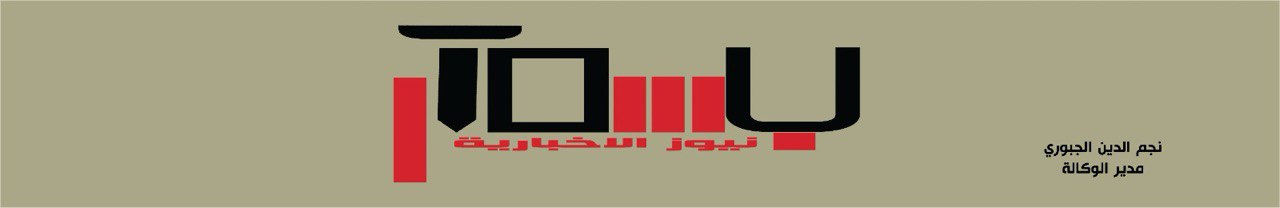آل البيت في الإسلام: نور النبوة وحقيقة المظلومية التاريخية
إعداد الكاتب والباحث/ عدنان صگر الخليفه
مقدمة: أهمية التاريخ ومكانة أهل البيت
إن التاريخ ليس مجرد سجل للأحداث الماضية، بل هو منبع للعبر والدروس التي تُشكل وعي الأمة وتُحدد مسارها. وفي تاريخ الإسلام، تُعد سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار منارة هدى، ومحورًا أساسيًا لفهم جوهر الرسالة المحمدية. لقد خصّ الله سبحانه وتعالى أهل البيت بمكانة عظيمة وخصوصيات فريدة، شهد بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مما يجعلهم قدوات خالدة لكل المسلمين. ولذلك، فإن فهم مكانتهم، وإبراز مظلوميتهم، وتصحيح الروايات التاريخية حولهم، ليس ترفًا فكريًا، بل واجب ديني وأخلاقي، يهدف إلى صيانة نقاء الإسلام وحماية ركائزه من التشويه.
آل البيت: مكانة ربانية وتطهير إلهي
لقد رفع الله تعالى شأن أهل بيت النبوة، وجعلهم منارًا للإسلام كله، لا لمذهب أو طائفة بعينها. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أبان مكانتهم بشكل لا لبس فيه. ومن دلائل هذه المكانة:
آية التطهير وحديث الكساء: حيث نص القرآن الكريم على إرادة الله بتطهيرهم: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الأحزاب: 33). وقد تواترت الروايات بأن هذه الآية نزلت في النبي محمد، والإمام علي، والسيدة فاطمة الزهراء، والإمامين الحسن والحسين، عندما جمعهم النبي تحت كساء واحد ودعا لهم بالتطهير. وهذا التطهير ليس مجرد تفضيل، بل هو إقرار بعصمتهم ونقائهم.
آية المباهلة: في موقف عظيم وشاهد تاريخي لا يُمكن إنكاره، دعا الله تعالى نبيه لمباهلة نصارى نجران، ليخرج معه: ﴿أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ﴾ (آل عمران: 61). وقد خرج النبي بأمر إلهي بعلي كـ “أنفسنا”، وفاطمة كـ “نسائنا”، والحسنين كـ “أبنائنا”. وهذا الاصطفاء لا يؤكد مكانتهم فحسب، بل يُبرهن على أنهم يُمثلون جوهر الإسلام وحجته البالغة، وأنهم ليسوا مجرد قرابة عابرة.
الأحاديث النبوية في فضلهم: أكدت السنة النبوية الشريفة على مكانة كل فرد منهم:
الإمام علي بن أبي طالب: هو من قال فيه النبي: “من كنت مولاه فعلي مولاه”، وهو بمنزلة هارون من موسى، وهو من قال بحقه رسول الله في غزوة الخندق: “خرج الإسلام كله إلى الكفر كله” عندما برز لعمرو بن ود العامري، وهو الذي بات في فراش النبي مفتديًا بنفسه ليلة الهجرة. كل هذه المناقب تُعلي من شأنه وتُثبت عصمته وبراءته مما ألصق به.
الإمامان الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا ليس لقبًا عاديًا، بل شهادة نبوية تُشير إلى طهارتهما ومكانتهما العظمى في الآخرة.
السيدة فاطمة الزهراء: هي بضعة النبي وسيدة نساء العالمين، ومن آذاها فقد آذى النبي نفسه.
شهادة الشعر: قصائد خالدة في مكانة أهل البيت ومظلوميتهم
إن التاريخ لا يُحفظ بالروايات فحسب، بل بالكلمة الصادقة التي تنبض بالحقيقة، والشعر هو ديوان العرب ومرآة العصور. لقد كان الشعر على مر العصور شاهدًا أمينًا على مكانة أهل البيت ومظلوميتهم، مُخلدًا ذكرهم ومُفحمًا من حاول تجاهلهم أو ظلمهم. وقد دأب شعراء تلك العصور على استذكار معركة كربلاء وتاريخها شعراً، مُجسدين عمق الفاجعة ومُبرزين مكانة الإمام الحسين.
من الشواهد الشعرية الخالدة التي تُبرز مكانة أهل البيت وتُفضح جهل الظالمين، قصيدة الفرزدق الشهيرة في حق الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليه السلام). لم يكن الشاعر الفرزدق يُعرف بأنه شاعر أهل البيت في ذلك الوقت، بل كان يُصنف ضمن شعراء البلاط الأموي. ولكن عندما ارتجل هذه القصيدة العصماء، لم يكن دافعه انتماءً مذهبياً بقدر ما كان دافعه الغيرة على الحق، والإنكار على تجاهل حقيقة واضحة، والغضب لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولآل بيت رسوله. كان ذلك عندما حج هشام بن عبد الملك، قبل أن يتولى الخلافة، وطاف بالبيت الحرام، وحاول أن يستلم الحجر الأسود، فلم يتمكن لكثرة الزحام. في تلك الأثناء، أقبل الإمام زين العابدين، فما أن رآه الناس حتى انفرجوا له إجلالًا وإكبارًا، فاستلم الحجر بسهولة ويسر. سأل هشام بن عبد الملك مُتجاهلًا أو مُتعمدًا الجهل: “من هذا؟” فما كان من الفرزدق إلا أن أجابه بقصيدة ارتجلها في الحال، مُبينًا مكانة الإمام وعظيم شأنه، مُفحمًا هشامًا ومُعرّفًا الناس بحقيقة الإمام، قائلًا:
> هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
> والبيت يعرفه والحل والحرم
> هذا ابن خير عباد الله كلهم
> هذا التقي النقي الطاهر العلم
> هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله
> بجده أنبياء الله قد ختموا
> وليس قولك: “من هذا؟” بضائره
> العرب تعرف من أنكرت والعجم
> يغضي حياءً ويُغضى من مهابته
> فما يُكلّم إلا حين يبتسم
> هذا ابن خير عباد الله كلهم
> هذا التقي النقي الطاهر العلم
> يكاد يمسكه عرفان راحته
> ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم
> ينمى إلى ذروة العز الذي شرفت
> به قيس وتسمو بعده مضر
> مشتقة من رسول الله نبعته
> طابت مغارسه والخيم والشيم
>
هذه القصيدة ليست مجرد أبيات شعرية، بل هي شهادة تاريخية حية من شاعر معاصر، تُسجل مكانة الإمام زين العابدين، وتُبرز جهل أو تجاهل الحاكم الأموي، وتُؤكد أن أهل البيت كانوا معروفين بعظيم شأنهم وطهارتهم حتى لمن يُحاول إنكار ذلك. إنها تُجسد كيف أن الحقائق لا يُمكن طمسها، وأن مكانة آل البيت راسخة في قلوب المؤمنين، وإن حاول الظالمون إخفاءها.
ولم تتوقف شهادة الشعر عند هذا الحد، بل استمرت عبر العصور لتُخلد مظلومية أهل البيت وتُعلي من شأنهم. ومن القصائد التي تُجسد عمق الفاجعة وتُبرز مكانة الإمام الحسين، تلك الأبيات التي قيلت في حضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، حيث تُروى قصة الشاعر دعبل الخزاعي عندما أنشد قصيدته التائية المعروفة، ومن ضمنها هذه الأبيات المؤثرة التي تُخاطب السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وتُصور فاجعة كربلاء:
> أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً
> وقد مات عطشانًا بشط فرات
> إذن للطمت الخد فاطم عنده
> وأجريت دمع العين في الوجنات
> أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي
> نجوم سماوات بأرض فلاة
>
هذه الأبيات، التي تُجسد الألم العميق وتُصور فاجعة كربلاء بأسلوب مؤثر، تُظهر كيف أن ذكرى مظلومية الإمام الحسين بقيت حية في الوجدان الإسلامي عبر الأجيال، وكيف أن الشعر كان وسيلة قوية للتعبير عن هذه المأساة، وتذكير الأمة بمكانة أهل البيت والتضحية العظيمة التي قدموها.
المغالطة التاريخية: تبرئة الظالمين وتشويه الحقائق
على الرغم من هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصريحة والمواقف التاريخية الثابتة، ظهرت لاحقًا محاولات لتشويه التاريخ وتزييف الحقائق، خاصة فيما يتعلق بظلم أهل البيت ومصير قاتليهم. هذه المحاولات لم تكن سوى دفاعًا عن الظالمين، ومحاولة لإلباس الباطل ثوب الشرعية.
إن من يُحاول تبرئة يزيد بن معاوية من دم الإمام الحسين، أو يُقلل من فداحة جريمته، أو يُشكك في مكانة الإمام علي ويُبرر قتال من حاربه، هو في الحقيقة يُواجه تناقضًا صارخًا مع ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله. فكيف يمكن لله، العدل المطلق، أن يرضى عن قاتل “سيد شباب أهل الجنة”؟ هذا السؤال يضع المتناقضين أمام خيارين: إما أن يكون هناك “مغالطة ربانية” (وهو مستحيل من حيث العقيدة)، أو أن تكون هناك “مغالطة تاريخية” تُصنع لتبرير الأفعال الإجرامية، وهذا هو الواقع.
إن محاولة حصر هذه الشخصيات العظيمة (آل بيت النبوة) في مذهب معين هي مغالطة كبرى أخرى. ففي زمن النبي والأئمة الأوائل، لم تكن هناك مذاهب فقهية بالمعنى المتعارف عليه اليوم، بل كانت هناك أتباع لكل شخصية قيادية. المذاهب (كالجعفرية، والشافعية، والمالكية، والحنفية) تبلورت بعد قرون من استشهاد الإمام الحسين، مما يؤكد أن أهل البيت هم رموز إسلامية جامعة، وقضيتهم هي قضية الإسلام كله، لا فئة معينة. وفي هذا السياق، فإن من سموا أنفسهم بـ “الشيعة” أو من أطلق عليهم أهل البيت وصف “شيعتنا” والمقربين منا، هم في الأساس أولئك الذين تمسكوا بمحمد وآل محمد، وتمسكوا بالأئمة الأطهار على أن يكونوا هم المنار لهم وامتدادًا لرسول الله. هذا التمسك والاتباع هو الذي أدى إلى تسميتهم بـ “الجعفرية” (نسبة إلى الإمام جعفر الصادق) و”الشيعة” (أي الأتباع)، مما يؤكد أن هذه التسميات نشأت من حقيقة التمسك بنهج أهل البيت، وليس من اختراع مذهبي لاحق.
فاجعة كربلاء: ذروة المظلومية وامتداد الثورات المطالبة بالثأر وحكمة أهل البيت
إن فاجعة كربلاء ومقتل الإمام الحسين عليه السلام هي ذروة هذه المظلومية. وقد بدأت فصول هذه المأساة العظمى عندما خرج الإمام الحسين من مكة المكرمة في موسم الحج، بعد أن أتم ركنًا أساسيًا من أركانه وهو الوقوف بعرفة. لقد آثر الإمام الحسين ترك إتمام مناسك الحج والتوجه إلى العراق، مدركًا حجم التحدي ومخاطر المؤامرة التي كانت تُحاك ضده، ومُفضلًا التضحية بنفسه وأهل بيته على أن تُهتك حرمة البيت الحرام أو أن يُستباح دمه فيه. هذا الخروج في مثل هذا التوقيت المقدس، يُبرز مدى إيثاره لدين الله وحرماته على حياته، ويُظهر أن حركته لم تكن سعيًا لسلطة دنيوية، بل كانت قيامًا لإصلاح أمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأوامر بقتله حتى لو كان متعلقًا بأستار الكعبة، مما يؤكد النية المبيتة لاغتياله بأي ثمن.
وبعد خروجه، تُشير بعض الأقوال إلى أن أهل الكوفة قد غدروا بالإمام الحسين، ولكن هذا الادعاء يحتاج إلى تدقيق. فالحقيقة التاريخية تؤكد أن الإمام لم يصل إلى الكوفة أبدًا. بل تلقاه جيش الحر بن يزيد الرياحي وأخذه إلى كربلاء، ولم يسمح له بالذهاب إلى الكوفة أو العودة إلى مكة، مما يؤكد أن الإمام كان مُحاصرًا، وأن مأساته لم تكن نتيجة غدر من طرف واحد بقدر ما كانت جزءًا من خطة محكمة للسيطرة عليه ومنعه من تحقيق أهدافه الإصلاحية. هذا يؤكد أن الإمام لم يكن مُقدمًا على معركة عشوائية، بل كان مُواجهًا لواقع فرضه عليه أعداء الحق، وأن من قتله لم يكونوا أنصار أبيه من أهل الكوفة، بل جيش السلطة الأموية الذي منعه من الوصول إلى الكوفة وحاصره في كربلاء.
إن كل هذه الأحداث تُشير بوضوح إلى أن معركة كربلاء لم تكن مجرد صراع عابر، بل كانت مخططًا لها ومرسومًا بدقة بهدف إبادة الإمام الحسين وأهل بيته دون إبقاء أي حي منهم. والدليل على هذا التخطيط المسبق يتجلى في قتل الأطفال الأبرياء، كأبناء مسلم بن عقيل، الذين تم تعقبهم وقتلهم في مدينة المسيب، بعيدًا عن ساحة المعركة الرئيسية. هذا الفعل الشنيع يؤكد أن الهدف لم يكن فقط القضاء على الإمام الحسين، بل استئصال كل من يمت بصلة إليه، حتى الأطفال الذين لا ذنب لهم، مما يُظهر مدى وحشية ودموية هذا المخطط الذي أراد طمس نور النبوة.
لم تنتهِ تداعيات فاجعة كربلاء عند استشهاد الإمام الحسين، بل كانت الشرارة التي أشعلت العديد من الثورات والانتفاضات المطالبة بالثأر لدماء أهل البيت، والتي كشفت عن مدى الظلم الذي لحق بهم. من أبرز هذه الثورات:
* ثورة المختار الثقفي: الذي خرج في الكوفة مطالبًا بالثأر للإمام الحسين وقتلة، وتمكن من القضاء على عدد كبير من المتورطين في جريمة كربلاء، مما يدل على أن القضية لم تكن لتُنسى، وأن هناك من استشعر المسؤولية تجاه هذه المظلومية.
* ثورة زيد بن علي زين العابدين: حفيد الإمام الحسين، الذي خرج مطالبًا بالعدل ورفضًا للحكم الأموي، مؤكدًا على استمرارية نهج أهل البيت في مقارعة الظلم، حتى وإن كلفهم ذلك حياتهم.
* قيام الدولة العباسية: التي استغلت شعار “الرضا من آل محمد” والمطالبة بثارات الإمام الحسين للإطاحة بالدولة الأموية. ورغم أن العباسيين سرعان ما تنكروا لوعودهم وظلموا أهل البيت لاحقًا، إلا أن صعودهم كان دليلًا قاطعًا على أن مظلومية كربلاء كانت قضية مركزية في الوعي الإسلامي، وأنها كانت قادرة على تحريك الجماهير وإسقاط الدول.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حكمة أهل البيت وعلمهم ومكانتهم لم تكن محل تجاهل حتى من قبل خصومهم السياسيين. ففي عهد الدولة العباسية، سعى الخليفة المأمون إلى استغلال هذه المكانة. فعندما أراد المأمون أن يُحكم سيطرته ويُقوي موقفه في صراعه مع أخيه الأمين، قام بتقريب الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وجعله وليًا لعهده. هذا القرار، وإن كان له دوافع سياسية واضحة، إلا أنه يُعد اعترافًا ضمنيًا بمكانة الإمام الرضا وعلمه وحكمته، وتأكيدًا على أن أهل البيت كانوا يمتلكون تأثيرًا روحيًا وعلميًا وسياسيًا لا يُمكن تجاهله، حتى في أوج الصراعات على السلطة.
لماذا قرب المأمون الإمام علي بن موسى الرضا إليه؟
لقد كان تقريب المأمون للإمام الرضا وجعله وليًا لعهده خطوة سياسية مُعقدة ذات أبعاد متعددة، ولم يكن الهدف منها مجرد إظهار الإمام كصاحب حق لانتصار المأمون على أخيه الأمين، بل كانت هناك دوافع أعمق:
* شرعية الحكم: كان المأمون يدرك أن الدولة العباسية قامت على شعار “الرضا من آل محمد” والمطالبة بثارات الحسين، ولكنها سرعان ما انحرفت عن هذا المسار وظلمت العلويين. بتقريب الإمام الرضا، كان المأمون يسعى لإضفاء الشرعية على حكمه أمام قطاعات واسعة من المسلمين، وخاصة الشيعة الذين كانوا يرون في أهل البيت الأئمة الشرعيين. كان يريد أن يُظهر نفسه كخليفة يسعى للعدل وإعادة الحق لأهله، وبالتالي كسب تأييدهم.
* امتصاص الثورات العلوية: كانت الدولة العباسية تعاني من كثرة الثورات العلوية في مناطق مختلفة من الدولة، خاصة في العراق وخراسان. بتقديم الإمام الرضا كولي للعهد، كان المأمون يأمل في امتصاص هذه الثورات وتهدئة الأوضاع، حيث سيجد العلويون أنفسهم أمام خيار صعب: إما الاستمرار في الثورة ضد خليفة يعتبر الإمام الرضا وليًا لعهده، أو القبول بهذا الترتيب.
* عزل الإمام عن قواعده الشعبية: يُرى أن المأمون كان يهدف أيضًا إلى إبعاد الإمام الرضا عن قواعده الشعبية في الحجاز، وإحضاره إلى مرو (عاصمة المأمون آنذاك في خراسان). بهذا، كان يُمكن للمأمون مراقبة الإمام عن كثب، والتحكم في تحركاته واتصالاته، وتقليل تأثيره المباشر على أتباعه.
* إظهار عجز الإمام: يُعتقد أن المأمون كان يهدف إلى إظهار الإمام الرضا بمظهر العاجز عن إدارة شؤون الدولة إذا ما تولى الخلافة، أو إظهاره بمظهر المتنازل عن حقه في الإمامة، وذلك من خلال إلزامه بالدخول في تفاصيل الحكم التي قد لا تتوافق مع نهجه.
* الصراع مع الأمين: في سياق الصراع بين المأمون وأخيه الأمين على الخلافة، كان تقريب الإمام الرضا وسيلة للمأمون لكسب تأييد الفرس، الذين كانوا يميلون إلى العلويين، ولإضعاف موقف الأمين في بغداد، حيث كان يعتمد على دعم العرب.
باختصار، لم يكن تقريب المأمون للإمام الرضا مجرد لفتة تقدير، بل كان مناورة سياسية مُحكمة تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية للمأمون في صراعه على السلطة وتثبيت أركان حكمه، مع استغلال المكانة الدينية والاجتماعية الرفيعة التي يتمتع بها الإمام.
إن ما تمسك به الشيعة من مظلومية الإمام الحسين ومظلومية الأئمة الأطهار من بعده لم يكن مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل كان منهجًا وطريقًا سار عليه الأئمة أنفسهم. لقد حرص الأئمة من نسل الإمام الحسين على إظهار هذه المظلومية وتواترها في نسلهم إمامًا بعد إمام، ليظل هذا الصوت يصدح بالحقيقة ويوقظ ضمائر الأمة. هذا التمسك بالمظلومية كان بمثابة أداة تعليمية وتوجيهية للمجتمع الإسلامي، يُبين الفارق بين نهج العدل الذي مثله أهل البيت ونهج الظلم الذي تبناه خصومهم. وبهذا، أصبحت المظلومية جزءًا لا يتجزأ من هويتهم ومنهجهم، وركيزة أساسية في دعوة الأمة إلى التمسك بالحق والعدل. ولأجل هذا، بقي الشيعة ملتزمين بما التزم به الأئمة الأطهار من إظهار مظلومية الإمام الحسين، فبعد رحيل الأئمة، ظل أتباعهم يواصلون هذا النهج، مُحافظين على ذكرى المظلومية كجزء لا يتجزأ من عقيدتهم وهويتهم، ومصدر إلهام لمقارعة الظلم والفساد.
لقد استقبل يزيد بن معاوية الرأس الشريف للإمام الحسين في قصره بدمشق، وتُشير الروايات التاريخية إلى أنه أخذ يضربه بقضيب كان في يده، ويضعه على فم الإمام، بل وتجرأ على إنشاد أبيات تُشير إلى الشماتة وإحياء لضغائن الجاهلية، كقوله:
> ليت أشياخي ببدر شهدوا
> جزع الخزرج من وقع الأسل
> لأهلوا واستهلوا فرحًا
> ثم قالوا يا يزيد لا تشل
> لعبت هاشم بالملك فلا
> خبر جاء ولا وحي نزل
> قد قتلنا القرن من ساداتهم
> وعدلنا ميل بدر فاعتدل
> وأخذنا من علي ثارنا
> وقتلنا الفارس الشهم البطل
>
هذه الأبيات، وهذا الفعل المشين، هي دليل دامغ على مدى البجور والشماتة، وتُثبت مسؤولية يزيد المباشرة وتُفنّد أي محاولة لتبرئته أو التقليل من جريمته. فالشخص الذي يأمر بقتل “سيد شباب أهل الجنة” ويُظهر هذه الشماتة، لا يمكن أن يكون مقبولًا في ميزان الشرع أو العقل.
الخلاصة: إبراز الحقائق لا طلب الثأر
إن بحثنا هذا لا يهدف إلى المطالبة بالثأر أو إثارة الضغائن، فالمعارك قد مضت عليها قرون، وتبعها ونتائجها تعود على من قام بها. نحن لسنا طلاب ثأر، بل طلاب حقائق. غايتنا الأساسية هي إيضاح الحقائق التاريخية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإبراز المظلومية العظمى التي حلت بآل بيت النبوة، دون تبرئة الظالم على حساب المظلوم.
تجدر الإشارة هنا إلى أن إظهار مظلومية الإمام الحسين والأئمة الأطهار ليس اتهامًا لأتباع المدارس الدينية الأخرى في العصر الحاضر. فاللوم التاريخي يقع على عاتق الأفراد والأنظمة التي ارتكبت تلك الجرائم في زمانها، وليس على الأجيال اللاحقة من المسلمين. إن الهدف من تسليط الضوء على هذه المظلومية هو الحفاظ على الحقائق التاريخية، واستلهام العبر منها في مواجهة الظلم في أي زمان ومكان، وتعزيز قيم العدل والتسامح المستوحاة من سيرة أهل البيت، وليس لإثارة الفرقة أو تبادل الاتهامات بين المسلمين اليوم.
إن الاعتراف بمظلومية أهل البيت ومكانتهم العظيمة التي خصهم الله بها ورسوله، هو في جوهره اعتراف بقيم الإسلام الأساسية. السكوت عن هذا الظلم أو محاولة تبريره هو إهانة للإسلام والمسلمين الذين بُنيت ركائزهم على النبوة وآل بيت النبوة، الذين ضحوا التضحية الأسمى لحفظ الإسلام والمسلمين. فالله قد ميّز خلقه، ومن يعتدي على من ميزهم الله، فإن عليه لعنة الله. ولا يُمكن أن يُرضى عن قاتل سيد شباب أهل الجنة، فهذا يتنافى مع عدل الله وحكمته.